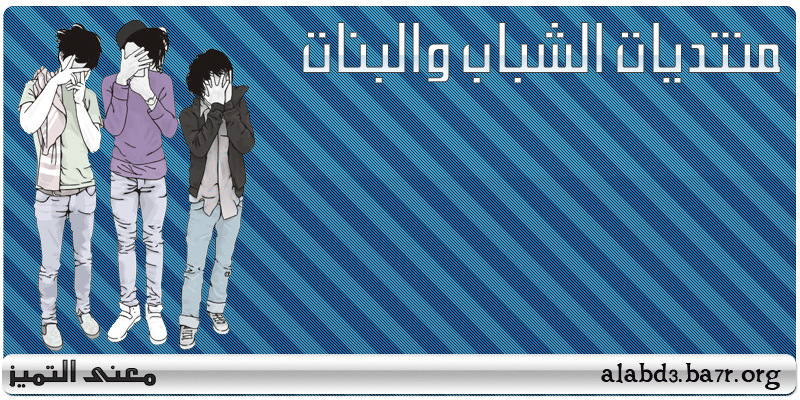المسرح المغربي
صفحة 1 من اصل 1
 المسرح المغربي
المسرح المغربي
إن ما نطلق عليه نعت المسرح المغربي، ليس إلا تلك الممارسة التي تمت بالفعل على أرض الواقع انطلاقا من العادات والتقاليد الاجتماعية التي تراكمت بفعل التواجد الاجتماعي للناس، الشيء الذي يجعل هذه الممارسة تنتمي إلى الموروث الثقافي الشعبي بإحالاته وتراتبيته في طقوس المقدس وما تراكمه على مستوى الوجدان الشعبي باعتباره نوعا من الوعي الحسي للناس لواقعهم والتفاعل معه في مضمرات هذا الوعي، الذي تشكل بفعل الممارسة الاجتماعية للناس في حياتهم، خاصة وأننا نعلم بانبنائية هذا الوعي من جراء نشوء وتكون المجتمع المغربي، تبعا لطبيعة ساكنته التي تمثل نوعا من الفسيفساء في تكونها بفعل النزوح والهجرة وتحولات أنماط الحكم التي كان عليها المغرب منذ وجود ساكنته الأولى الأمازيغ. وضمن هذا التشكل ستبرز أنواع من التعبيرات الفنية سواء كتعبير فن القول أو تعبيرات ذات طابع فني راق عن طبيعة هذا التشكل والتكون بحيث تندمج هذه التعبيرات في أنواعها وتعدد ما نسميه النسق الثقافي العام للبلاد والذي تكون هو أيضا من وعي الناس بواقعهم الاجتماعي كثقافة وطنية في مجتمع مفتوح تحدده شروط هذه الثقافة وإلا لما كان حديثنا عن التحول والنزوح بهذا المعنى وفي هذا المقام .
إننا نعتبر هذه الممارسة الفنية ممارسة مسرحية بالدرجة الأولى مادامت الممارسة المسرحية في حد ذاتها هي ممارسة فرجوية تحقق الالتقاء الحميمي بين الناس سواء كمؤدين أو كمؤدى لهم داخل المجتمع، لأن ما يؤدى هو الذي يحقق طبيعة اللقاء واللحمة الاجتماعية بين الناس ويعمل من خلال آليات الفرجة بما هي آلية سيكولوجية على تحقيق الاندماج الاجتماعي والتواصل، الشيء الذي تؤكده الدراسات الأنتروبولوجية[1] في هذا المجال، حيث قامت التجارب المسرحية لكبار المخرجين مثل بيتر بروك، وأريان بوشكين، وجيرزي غروتوفسكي على نتائج هذه الدراسات، مثلما قام به يوجينو باربا وادوارد هال وديابورا انطلاقا من المسعى الأول عند أنطوان أرتو في إنجاز فرجة مسرحية من هذه العادات إذ كان ينظر إلى ذلك فيما شاهده لدى شعوب جزيرة بالي بأندونيسيا. وقد تم تأكيد هذا المسعى في البحوث التي قام بها كلود ليفي ستراوس في هذا الميدان ونفس المسعى نجده في دراسات عبدالله حمودي في الأطلس الكبير بالمغرب[2].
إن اعتبار الممارسة المسرحية المغربية ممارسة ضاربة في القدم، إن لم نقل إن لها نفس تاريخ وجود الإنسان بهذه المنطقة مثلما هي عليه الحال باقي المجتمعات البشرية، يأتي من كون هذه الممارسة لا زال لها حضورها القوي فيما تختزنه الثقافة الشعبية، وتمدنا به على مستويات تمظهرات هذه الثقافة في سلوكنا اليومي المعيشي، ومنها أصبح المسرحيون المغاربة يستمدون موضوعاتهم وطرق اشتغالهم في بناء الفرجة المسرحية ونذكر منها على الخصوص فرجة اعبيدات الرمى، والبساط والمداح والرواي والحلقة[3] والتي يمثل انعقاد لقاءاتها ومواسمها فرص اجتماعية للإعلان عن حضور الذات الجمعية للناس والانتماء لهوية الجماعة حسب مواقع تواجدها على خارطة المغرب، إضافة إلى انخراط مكونات الساكنة فيها بالحضور والمشاركة ولا تفصل بينها فواصل السلالة والعرق أو المعتقد الديني ما دامت فرجات جماعية ترتكز على العمل وأنماط الإنتاج السائدة وفق الوسائل المتاحة لها حسب متطلبات الحياة نفسها آنذاك وحسب التحولات الاقتصادية والسياسية، التي تكون عليها الحقب التي مرت بها البلاد والتي تبقى موسومة بشرط التواجد الاجتماعي للناس، علما بأن هذا النمط من الحياة ومنتوجاته الثقافية تدخل في إرساء مدماكه القرار السياسي للسلطة الحاكمة[4].
إن أسئلة النشأة والتأسيس في المسرح المغربي تبقى أسئلة ذات طابع ثقافي فكري عام يؤرخ بها لمراحل تنامي الوعي بالذات ورد الفعل إزاء الآخر الذي استطاع أن يطور تجربته في نفس المجال وفي إطار سياق شروط تحولاته الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الارتقاء بوعيه الحسي، والذي أصبح وعيا بواقعه الاجتماعي والذي ترجم في تعبيراته الفنية وانطلاقا من عاداته وتقاليده والتي هي شبيهة والى حد كبير بالعادات والتقاليد التي تكونت عندنا في نشأة وتكون مجتمعاتنا بتشكيلاتها الاجتماعية وبتعالقها بمواقع السلطة فيها، وهو ما يمكن أن نلمس بعض التبساته في واقعنا من جراء التدخل الممارس بعنف مع الشعوب والذي يأخذ في كثير من الفترات طابعا صراعيا، ناهيك عن صراعاته الاجتماعية الداخلية، بحيث ننسى في خضم هذا تاريخنا الاجتماعي والثقافي ولا نفتح حدودا بين هذا التاريخ وتواريخ الشعوب الأخرى التي نتقاطع معها وما يبقى ماثلا أمامنا هو حدود هذا التقاطع بين التواريخ لصنع بدايات جديدة لتاريخنا الثقافي، ونغفل إننا في كل موسم أو مناسبة دينية أو وطنية نعمل على إحياء تاريخنا المنسي هذا باعتباره تركة موصولة الفعل وغير مستأنفة وهي ما تم التأشير عليها حاليا بالعودة الى الفرجة[5]<5>، انطلاقا من موروثنا الثقافي وما يحمله من حس الوجدان الشعبي، باعتبار هذا الوجدان تراثا وخزانا للوعي الوطني ولهويتنا، وكل عودة إليه هي عودة لإثبات الذات، ليس كرد فعل بل كواقع كان موجودا وحاضرا بقوة، بل وما يزال مستمرا ويعيد ترتيب حضوره في هذه المناسبات والمواسم وطقوس احتفالية تعطيه تماهيه في تقاطع تاريخه بتواريخ الآخر الذي نريد تمثل ثقافته وفنه بقوة حضوره العسكري، والتكنولوجي وكأننا لم نكن هنا ولم تكن لثقافتنا وفننا قائمة[6].
إننا نعتبر هذه الممارسة الفنية ممارسة مسرحية بالدرجة الأولى مادامت الممارسة المسرحية في حد ذاتها هي ممارسة فرجوية تحقق الالتقاء الحميمي بين الناس سواء كمؤدين أو كمؤدى لهم داخل المجتمع، لأن ما يؤدى هو الذي يحقق طبيعة اللقاء واللحمة الاجتماعية بين الناس ويعمل من خلال آليات الفرجة بما هي آلية سيكولوجية على تحقيق الاندماج الاجتماعي والتواصل، الشيء الذي تؤكده الدراسات الأنتروبولوجية[1] في هذا المجال، حيث قامت التجارب المسرحية لكبار المخرجين مثل بيتر بروك، وأريان بوشكين، وجيرزي غروتوفسكي على نتائج هذه الدراسات، مثلما قام به يوجينو باربا وادوارد هال وديابورا انطلاقا من المسعى الأول عند أنطوان أرتو في إنجاز فرجة مسرحية من هذه العادات إذ كان ينظر إلى ذلك فيما شاهده لدى شعوب جزيرة بالي بأندونيسيا. وقد تم تأكيد هذا المسعى في البحوث التي قام بها كلود ليفي ستراوس في هذا الميدان ونفس المسعى نجده في دراسات عبدالله حمودي في الأطلس الكبير بالمغرب[2].
إن اعتبار الممارسة المسرحية المغربية ممارسة ضاربة في القدم، إن لم نقل إن لها نفس تاريخ وجود الإنسان بهذه المنطقة مثلما هي عليه الحال باقي المجتمعات البشرية، يأتي من كون هذه الممارسة لا زال لها حضورها القوي فيما تختزنه الثقافة الشعبية، وتمدنا به على مستويات تمظهرات هذه الثقافة في سلوكنا اليومي المعيشي، ومنها أصبح المسرحيون المغاربة يستمدون موضوعاتهم وطرق اشتغالهم في بناء الفرجة المسرحية ونذكر منها على الخصوص فرجة اعبيدات الرمى، والبساط والمداح والرواي والحلقة[3] والتي يمثل انعقاد لقاءاتها ومواسمها فرص اجتماعية للإعلان عن حضور الذات الجمعية للناس والانتماء لهوية الجماعة حسب مواقع تواجدها على خارطة المغرب، إضافة إلى انخراط مكونات الساكنة فيها بالحضور والمشاركة ولا تفصل بينها فواصل السلالة والعرق أو المعتقد الديني ما دامت فرجات جماعية ترتكز على العمل وأنماط الإنتاج السائدة وفق الوسائل المتاحة لها حسب متطلبات الحياة نفسها آنذاك وحسب التحولات الاقتصادية والسياسية، التي تكون عليها الحقب التي مرت بها البلاد والتي تبقى موسومة بشرط التواجد الاجتماعي للناس، علما بأن هذا النمط من الحياة ومنتوجاته الثقافية تدخل في إرساء مدماكه القرار السياسي للسلطة الحاكمة[4].
إن أسئلة النشأة والتأسيس في المسرح المغربي تبقى أسئلة ذات طابع ثقافي فكري عام يؤرخ بها لمراحل تنامي الوعي بالذات ورد الفعل إزاء الآخر الذي استطاع أن يطور تجربته في نفس المجال وفي إطار سياق شروط تحولاته الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الارتقاء بوعيه الحسي، والذي أصبح وعيا بواقعه الاجتماعي والذي ترجم في تعبيراته الفنية وانطلاقا من عاداته وتقاليده والتي هي شبيهة والى حد كبير بالعادات والتقاليد التي تكونت عندنا في نشأة وتكون مجتمعاتنا بتشكيلاتها الاجتماعية وبتعالقها بمواقع السلطة فيها، وهو ما يمكن أن نلمس بعض التبساته في واقعنا من جراء التدخل الممارس بعنف مع الشعوب والذي يأخذ في كثير من الفترات طابعا صراعيا، ناهيك عن صراعاته الاجتماعية الداخلية، بحيث ننسى في خضم هذا تاريخنا الاجتماعي والثقافي ولا نفتح حدودا بين هذا التاريخ وتواريخ الشعوب الأخرى التي نتقاطع معها وما يبقى ماثلا أمامنا هو حدود هذا التقاطع بين التواريخ لصنع بدايات جديدة لتاريخنا الثقافي، ونغفل إننا في كل موسم أو مناسبة دينية أو وطنية نعمل على إحياء تاريخنا المنسي هذا باعتباره تركة موصولة الفعل وغير مستأنفة وهي ما تم التأشير عليها حاليا بالعودة الى الفرجة[5]<5>، انطلاقا من موروثنا الثقافي وما يحمله من حس الوجدان الشعبي، باعتبار هذا الوجدان تراثا وخزانا للوعي الوطني ولهويتنا، وكل عودة إليه هي عودة لإثبات الذات، ليس كرد فعل بل كواقع كان موجودا وحاضرا بقوة، بل وما يزال مستمرا ويعيد ترتيب حضوره في هذه المناسبات والمواسم وطقوس احتفالية تعطيه تماهيه في تقاطع تاريخه بتواريخ الآخر الذي نريد تمثل ثقافته وفنه بقوة حضوره العسكري، والتكنولوجي وكأننا لم نكن هنا ولم تكن لثقافتنا وفننا قائمة[6].
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى